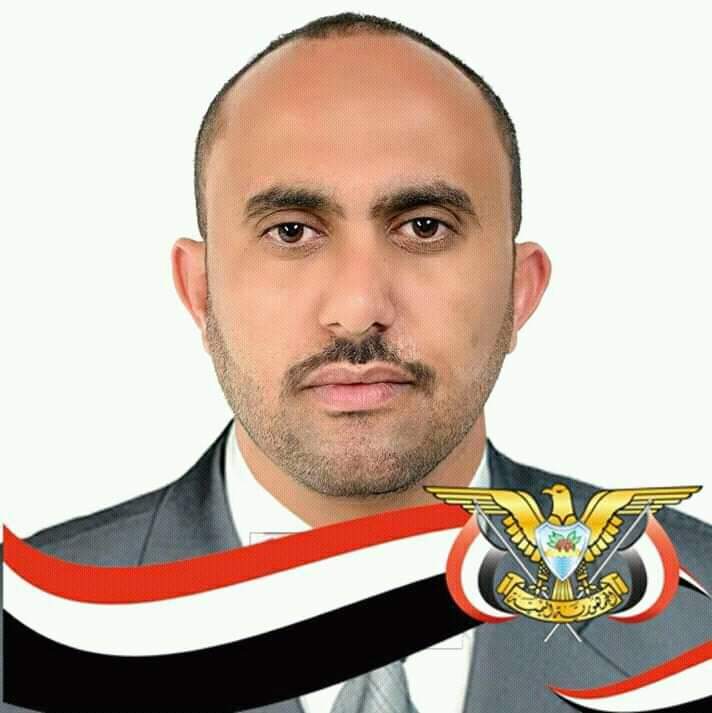وبما أن مجهولًا أنجب هذه الصفحة، ورماها لقدرها، قررت أن أشارك في تربيتها أجرًا وثوابًا، وإحاطة وذكرى، ولزومًا لوصل أصدقاء رحلوا وغادروا صامتين يلفهم هجوع الأزمنة المتتالية، فلا نكاد نسمع لهم ركزا
في اليوم الأول إلى بلوغ صنعاء، رؤية "باب اليمن"، ومشاهدة أهل تلك البلاد اللاهثة بلهجتها، أولئك المركزيون في سلطتهم وصحافتهم وإعلامهم، كنت محتفلًا بكوني أصغر طلاب الجامعات قاطبة، بدأت لتوي عامي الـ 17 قادمًا كـ "رئيس تحرير" إلى أرض لا تشبه "ذمار" وعالم غريب من الصداقات الصغيرة ، مُحملًا بـ "زنجبيل" مدينتي، وإرث القبيلة التي جاء منها أسلافي، ولم يكن أبي ليتركني أسافر تلك البلاد البعيدة وحيدًا، أرفقني في إبط صديقي الكبير الرسام "عبدالله الكوماني" ورجاه يائسًا أن يقنعني في محاولة أخيرة لدخول كلية التجارة، وأردف : الإعلام ليس عملًا !
وعلى جدار مبنى بالقرب من الانتربول، انحدرت عبر الدرب إلى شارع كبير وأسرعت الخطى إلى شارع فرعي آخر، أسأل عنها بوجد، وبدت أمامي، ورق قلبي، واضطرب، مبنى طويل مثل برج قصير، وحولها هرج كثير، وجماعات تحوم حول بعضها، وبعينين زائغتين من فرط اللهفة، بأنفاس متلاحقة قلقًا ورهبة، دخلت، بالقدم اليمنى كما قالت المرحومة أمي، وقد ودعتني بعينين دامعتين حتى آخر منعطف في حيّنا، أرسلت معها قلبها في عنايتي، وغايتي، ودعواتها تحفني كولد مبارك، ثم سمعت همسًا عن شابة تتوقد لطفًا وجرأة وجمالًا، قالت فتاة لصديقها : هذه رحمة حجيرة !، وهمس الفتى مبهورًا لصديقته : نعم وقد أفردوا لها في صحيفة الحارس عمودًا تكتبه كل أسبوع.
كانت رحمة حجيرة على وشك التخرج، ونبيل سيف الكميم يضحك بعصبية في مقهى الكلية، وأمام لوحة الإرشادات وقف شاب يمتاز حيوية، عرفني بنفسه : فارس الجعماني، وسألته عن قرابته بـ "جعماني مؤسسة الثورة" وكشف لي أنه والده، وقد عرفته خلال رحلتي المتنقلة بين "باصات" صنعاء وصولًا إلى مقر عمله في المنفى البعيد، ولا أدري اليوم إن كان حيًا أو حملته ملائكة الله إليه، مبتسمًا مطمئنًا كما كان في دعة ولطف غامرين .
صعدت إلى غرفة العميد مباشرة، درج كثير، وهمس يكتشف الشخصيات الإعلامية التي جاءت لإستعراض حضورها، أتذكر أني عدت إلى كلية الإعلام في مبناها الجديد بعد تخرجي بخمس سنوات، ظنًا أنهم سيهمسون "هذا سام"، فابتسم كـ "المشاهير" وأمضي في طريقي إلى قلب مكتب شؤون الطلاب، فلم أسمع هسيسًا لأحد، حتى أنقذني "خليل العمري" إذ ناداني فأقبلت عليه، مصافحًا مُرحِبًا، ومتخليًا عن غرور "الشهرة"، أكاد أقبّل يديه لأنه عرفني أخيرًا !
وعند رواق مكتظ بالبنات، اختارتني "مها البريهي" لسؤالها : أين مكتب العميد ؟، فكدت أسقط مغشيًا، لفرط جمالها، وأبهتها ولباسها اليماني بحمرة وسواد ورسوم تشكيلية نحتت في ردائها لوحة زادت وجهها المنير ألقًا وحضورًا، وأجبت تائهًا : أنا أبحث عنه أيضًا، وظننت أنها سترافقني للبحث سويًا، لكنها تركتني وبحثت لوحدها، فوجدته قبلها، وألفتني عند بابه داخلًا مبتسمًا لجائزتي، وهناك كانت سُمرة الدكتور "باسردة" وتطلفه بي شيئًا نادرًا قلّ أن يجتمعا، وحين خرجت كانت "مها" لا تزال جالسة بانتظار دورها .
لكزني "عبدالله الكوماني" حسدًا، وعيناه تمسحان خارطة التواجد النسائي في فناء الكلية، مؤكدًا أنه سيعود إلى أبي ليمنعني عن دخول هذا العالم "المتبرج" !، وأقبلت "بشرى فقيرة" كمهرة تنفض غرتها في وجه الشمس، وترفع قائمتيها الأماميتين لتصهل، وتعدو نحو تلال بعيدة، وتعود فيعود معها وعي الحاضرين والحاضرات والطلاب والطالبات، والأنس والجان، ودان دان .
رأيتها من شرفة "مقيل" القاعة (أ)، وهرعت السلالم برفقة صديق يفكر بالإلحاد، نحوها، ومازلت تصهل، تنثر العبير، وترهبنا، ترعبنا، تدمر كل نساء الكون اللائي عرفناهن قبلًا، ومضت بجواري مثل ريح طيبة، فوّاحة بيضاء من غير سوء، وكانت تلك اللحظة الأخيرة التي أراها فيها، اختفت، ابتعلها زواج، أو التهمها إكتئاب، أو ماتت على عجل بلا رثاء، وكأنني أصبتها بعين فتى لا يردعه خجله عن إظهار لهفته .
كانت دفعتي السابعة، انتظمت فيها عامًا، ثم أخذتني ظروف قاهرة إلى البقاء في مدينتي، وغبت عامين لأعود في التاسعة، حاولت أن أصبح طالبًا منتميًا لدفعتي الجديدة، وأصدقائي الجدد، لكني لم أستطع، كان قلبي في السابعة، وفي آخر العام الرابع بقيت معلقًا بمادة واحدة تركتها هناك، وكرهت صنعاء عمدًا، رسبت في الإحصاء، حتى خرجت مع أهل الدفعة الثالثة عشرة، لا أعرفهم ولا يعرفونني . وكانت هذه بعض حكايتي .