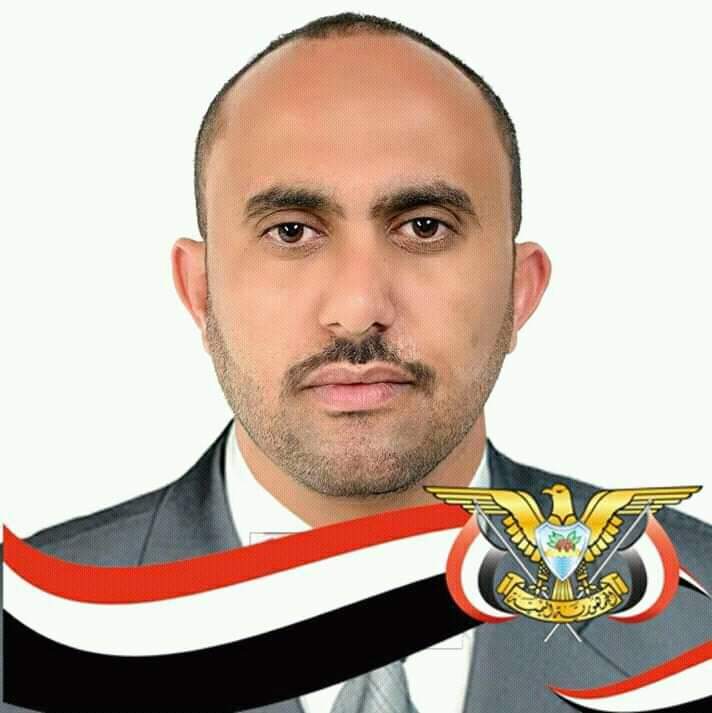ترتبط اختيارات الإنسان بعوامل عِدَّة، تُحدِّد الاتِّجاهات الرئيسية لحياته، كالانتماءات والأفكار والثقافات، حتى أنواع الموسيقى والأطعمة المفضَّلة. ولعلَّ خبرة الإنسان وتَوسُّع معرفته، إضافةً إلى الاختبارات الشخصية التي يعيشها، تُمثِّل أداة فاحصة لهذه الخِيارات مع مرور الوقت، وتَسمح بالإضافة أو التبديل لِما يتناسب منها، بحسب وجهات النظر ذات الطابع المتغيّر.
بينما يعيش الفرد اختبار القناعات الشخصية المستمر، يعيش المجتمع في المقابل هَوس التصنيف لهذا الفرد. وهو سلوك يحتاج إليه المجتمع –حسب ما هو معلوم- لتعريف الأفراد، ووضع عناوين لهم. ومع ارتفاع الحاجة إلى هذا التصنيف، يجري وصل الفرد بانتماءات معينة، سواءٌ سياسيّةً كانت أو ثقافية أو دينية. وهنا، تَبرز المشكلة. فالمجتمع عادةً ما يذهب في رحلة التصنيف إلى وضع الأفراد في خانات الانتماءات، باعتبارها أمورًا تتسم بالثبات، ومِن ثَمَّ يُقدِّمهم كمنتَجات غير قابلة للتحوُّل أو التبدل أو التغيير.
دائمًا ما تُحال الأفكار الفردية البَحْتة إلى الانتماءات الجمعية. فيصبح الفرد كائنًا مُجيَّرًا لمصلحة انتماء أو قناعات، اكتُشفت في مرحلة زمنية من حياته، لكنها ليست نهائية، حتى وإن قال الفرد عكس ذلك. هذا السلوك يبدو كإعلان نتيجة في منتصف وقت الاختبار، ويبدو الأمر أكثر صعوبة، إذا ما بدَّل الفردُ خِياراته، وقرَّر الإفصاحَ عن انتماء جديد، أو اختيار مختلف لِما عرفه الناس عنه. هنا، يقف المجتمع حارسًا للانتماءات اللحظية، وتبدأ حفلة التشهير والتخوين، وتنهال على الفرد الوصايا والنصائح، باعتباره خارجًا عن الطريق (أيِ الطريق الذي رسمه له المجتمع)، ويجري التعامل معه كمُنتَج ينتمي إلى مُصنِّع ذلك الانتماء فقط. وبذلك، لا يَصلح لأن يعيش اختباراته وخياراته الشخصية.
من ناحية أخرى، قد يواجه فردٌ ما حملة تشكيك من صاحِب انتماء جديد، فيَقتنع به ويقرِّر الالتحاق به التَّوَّة، لكنَّ ماضِيهِ يظلُّ مرافقًا له. ففي كل حدث أو حديث، يذكِّره صاحبُ الانتماء الجديد بعبء تجربته القديمة، وبأنه أقلُّ انتماءً إلى أفكاره الجديدة، بسبب خياراته السابقة التي تبنّاها.
يتذرع بعضهم بفكرة ثبات المبادئ، وهي فكرة تبدو كأُحْجِيَّة. فمع حاجة المجتمع إلى وجود قِيَم فُضلى تُرشِّد حالة السلوك الإنساني، يذهب الكثيرون إلى الخلط بين المبادئ والخيارات الشخصية الفردية اللحظية، وتَغدو المبادئ في نظرهم هي تلك الاختيارات، في حين تصبح المبادئ التي تَضمن وتصون حريات الفرد الشخصية مَحلَّ نقاش، حول ضرورة البقاء في سقف لا يتجاوز الانتماءات المقدَّسة لدى تلك المجتمعات. لاحقًا، يُوصَف مَن يغيِّر خياراته بخيانة المبادئ، مِن قِبل أَتْباع الهُويَّة القديمة، وربَّما بعض أفراد الهُويّة الجديدة.
هذا الواقع، يجعل الفرد يتمسك بقناعات غير مرغوب فيها، تَجنُّبًا لسيل النقد من محيطه الاجتماعي، الذي لن يرحمه إذا ما اكتَشف قناعاته الجديدة. وهو الأمر الذي يؤدي إلى ظاهرة الضغط الاجتماعي، الذي ينشأ عند قيام شخص ما بتقييم الحالة على أنها ذات صلة شخصية، ويُدرك أنه لا يملك المَوارد اللازمة للتغلب على الوضع المحدَّد، أو لا يستطيع القيام بالتعامل معه. فلا يجب بالضرورة أن يَحدث حدث يتجاوز القدرة على التأقلم لكي يواجه المرء ضغوطًا؛ إذ الخيارات الصغيرة أحيانًا تُمثِّل مصدرًا أيضًا لهذه الضغوط (بحسب عالم النفس ريتشارد لازاروس).
تبعًا لذلك، يتحول المجتمع إلى أفراد يعيشون بغير قناعة، ويقومون بسلوكيات لإرضاء محيطهم، وليس للتعبير عن قناعاتهم؛ ما يُحوِّل الحياة إلى مسرح كبير لظاهرة الفِصام المجتمعي. وما يزيد من سوء هذه الإشكالية، وُجودُ ظاهرة الاستقطاب السياسي والديني والثقافي، التي نُعانِيها في مجتمعاتنا، والتي تتعامل مع الحياة كمضمار نِزال، الأفراد فيه ليسوا سوى مادة للسباق، تتولى الجماعات فيه مهمَّة زيادة أَتْباع مسارات الماراثون، وحراسة التخوم خاصتها، لكي لا يتسرب منها أحدٌ من الأتْباع.
إن فكرة التَّقوقع في الانتماءات أو التصنيفات الثابتة، سواءٌ من ذات الفرد جاءت أو من المحيط الاجتماعي، ليست سوى قيْد كبير، يَحجب الإنسانَ عن الإبداع الخلَّاق في تطوير خياراته، واكتشاف بدائل انتماءاته. أيضًا يَخلق مجتمعات منفصلة، بقناعات خاطئة، فَحْواها أن الإنسان يولد بقالب مجتمعه، ومهمَّته تَكمن في الحفاظ عليه، والنضال من أجله حتى خط النهاية.