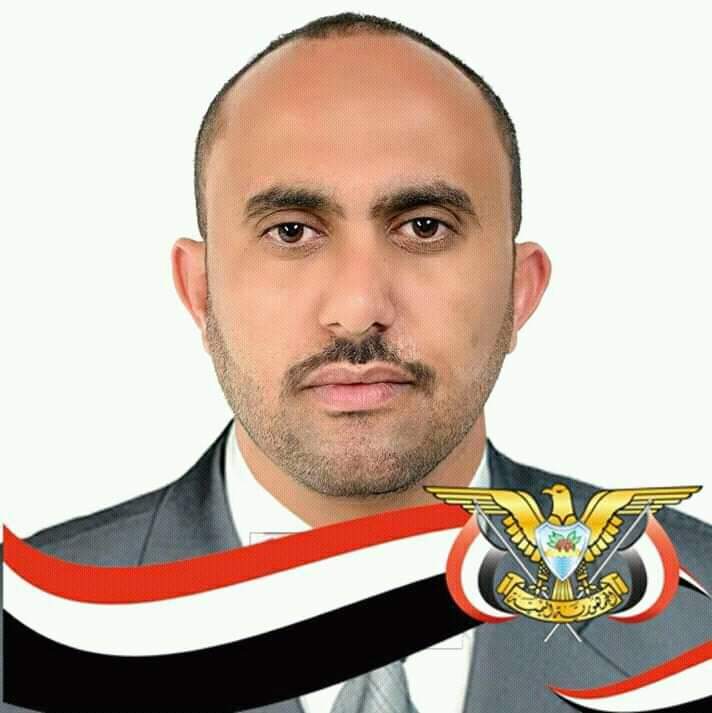في بعض المناطق العربيّة، ما زال الأب يذهب إلى المدرسة في بداية كلِّ عام دراسي، ليَمنح معلِّمي ابنه او ابنته تصريحًا مفتوحًا بالعقاب، قائلًا: “لا تُبقوا سوى اللَّحم والعظم”. هذه هي كلمة السِّرِّ الَّتي يجري تمريرها في حالة من الزَّهو، من قِبَل السُّلطة المنزليّة الممثَّلةً بالأب، إلى السُّلطة المدرسيّة الممثَّلة بالمعلِّم، في إشارة إلى استخدام الضَّرب المُبرِّح في التَّربية، ليجد الأطفال أنفسهم تحت سطوة العصا، الَّتي تُلاحقهم أينما ذهبوا.
مع افتراض حُسن النِّيّة لدى الآباء في قول عبارة كهذه، إلَّا أنّها تكشف حالة عميقة من العجز التَّربويِّ، الَّذي لا يرى النَّمط السَّويّ للتَّنشئة، إلّا من خلال عنف العقاب. فالأب الَّذي يقول اليوم عبارة العصا، هو نفسُه كان طفل الأمس، الذي قيل لمعلِّمه ذات العبارة من والده. وحتَّى يحافظ الأب على هذه المتوالية من التَّربية القادمة من الأسلاف، يقُوم بنقلها إلى الجيل الجديد.
تزخر الثَّقافة الشَّعبيّة بالكثير من الوصايا، الَّتي تتمحور حول الأنماط التَّربويَّة ذات النَّزعة العنفيّة. فـ “العصا لمن عصى”، والعصا أيضًا “جاءت من الجنَّة”، أو “العصا جَدُّها شريف”، كما تقول الحكايات والأمثولات الشَّعبيَّة. فتُشكِّل هذه القواعد العفويَّة مخزونًا إدراكيًّا لنمط التَّعامل داخل النُّظم الاجتماعيَّة، بدءًا من الأسرة، ثم المَدرسة، وُصولًا إلى الفضاءات العامَّة الَّتي ينخرط فيها النَّشء لاحقًا. منهجيَّة العصا هذه، أكبر من أن تكُون أداة أو وسيلة مؤقَّتة، بل هي جزء من الموروث الاجتماعي والتَّربويّ، الَّذي تُفرزه الثَّقافةُ والذَّاكرة الجمعيَّتَان، وتبني التَّصوُّرَ العامّ لِمَا يجب أن يُعمل عند مواجهة المشاكل. فالأساليب العنفيَّة -بحسب ذلك التَّصوُّر- ذات جدوى ونتائج سريعة من النَّاحية العمليَّة، في حين الوسائل اللَّاعنفيّة تبدو غير مُجْديَة، وتتطلَّب وقتًـا وجهدًا أطول، ولا يبدو أن الكثير من المجتمعات مستعدَّة للاستثمار فيهما.
تزداد خطورة هذه المقارَبة العنفيَّة، عندما تُهيمِن على البيئات المحيطة بالنَّاشئة، فتتحوَّل إلى مَعْمل تدجين كبير للجيل الجديد. فحين يرتكب الطِّفل(ة) خطأً في البيت يُصْفع، وحين يخسر علامةً في المدرسة يُجْلد، وحين يَحضر مجالس الثَّقافة الدِّينيّة يُضْرب بسَوط الوعيد والعذاب. كلّ هذه المظاهر تشير إلى نسقٍ عامٍّ يُفرزه المجتمع، أو -بتعبير (بيير بورديو)- نسقِ العنف الرَّمزيّ الَّذي يستخدمه المجتمع -تحت رعاية الطَّبقة المسيطرة-، لإعادة إنتاج الأفراد داخل قالب المُواطِن، المُهيَّأ مجتمعيًّا للاندماج في المجموع، والانصهار داخل النِّظام. فـ”كلُّ مجتمَع يمتلك مشروعًا اجتماعيًّا”، يكيِّف أفراده مع هذا المشروع من خلال التَّربية والتَّنشئة، ويقُوم بتهيئتهم ليتوافقوا مع متطلَّبات هذا المشروع” -بحسب بورديو-.
مع مرور الوقت، يُفرز المجتمع مُعاقِبِين جُدُدًا. والجيل الذي ضُرب بالعصا بالأمس، يصبح حاملها اليوم. وفي هذه المرحلة، تتجسَّد العصا على صُوَر وأشكال مختلفة. فتُصبح سَوطًا أكبر، أو بندقيّةً، أو مَدْفعًا. وفيها يصير الجيل الَّذي اعتَمد العصا كأسلوبٍ عامٍّ في المعالجة، لا يرى الحياة إلَّا ظَهْرًا أعوَجَ لا يستقيم إلَّا بتساقط الضَّربات. وفي الحضور الجمعيِّ لجيل العصا، تُصبح الحروب والنِّزاعات العنيفة، الوسيلةَ الوحيدة إلى التَّسويات، والتَّعبير الأوحد عن وجهات النَّظر المختلفة.
من ناحية أخرى، تتضخَّم العصا، فتُشكِّل بانوراما العقاب المَدرسيَّ على كِبَر، ويجري فرز مجموعة من حامِلي العصا في المجتمع، يتولَّون ممارسة العنف أو التَّلويح به ضدَّ الآخرين. فتَظهر المجتمعاتُ غير السَّويّة كنتيجة طبيعيَّة لذلك، ويجري إنتاج سلسلة العنف والعنف المضادّ من رَحِم هذا النَّسق. ويزداد المَشهد تعقيدًا، حين تُصبح السُّلطة النَّاظمة لأمر المجتمع حاملةً للعصا ضدّ مَن يخالفها، متَّبعة السُّلطة الأبويّة المطلَقة؛ ما يُحيلها لاحقًا إلى سلطة مستبِدّة، لا ترى مَصالح المجتمع إلّا مِن خلال رأس العصا. فالمستبِدُّ في جوهره عصا متضخِّمة.
في الحديث في معالجة ظاهرة العنف هذه، لا بدّ من الالتفات إلى المنشأ الأول، وإلى المَصدر الخام في تكوينها، حيث عادةً ما تقع في الأيّام الأولى، في الحُجرات المَنزليّة والمَدرسيّة، في الأحاديث البسيطة الّتي تَحمل عُنفًا عفويًّا متوارَثًا. فالتَّغيير يبدأ من هذه المرحلة، ولا يمكن إيقاف عنف المَدفع غدًا، إنْ برَّرْنا ضربة السِّواك اليوم. فالعنف ليس سوى إفلاس تربويٍّ واجتماعيّ، يعبِّر عن حالة فقر الوسائل والثَّقافة، ويجعل الحياة تَيْهًا ليس له نهاية. أمّا العصا، فهي بِلا شرف إن رُفِعتْ، وقيمتُها العُليا أن تَسنُد إنسانًا، لا أن تَكسِره.